
هى : أنا فقط أحببتُه أكثر مما يحتمله قلبٌ بشري .. هو : لم أمت حين تركتني… لكن شيئًا فيَّ دُفن حيًّا ولم يعد
فلسفة غوغائية : يكتبها على خليل 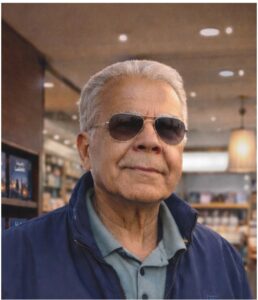
لم يبدأ الحب على الأرض، بل بدأ قبل أن تعرف الأرض معنى الانتظار. لم يولد بين جدران ولا تحت سقف، بل في فضاءٍ لا يعرف الخسارة ولا الفقد ولا الخوف. هناك حيث وُجد الإنسان أول مرة، لم يكن الحب وسيلة للبقاء، بل كان هو البقاء ذاته. حين خُلق آدم لم يكن ناقص الخِلقة، بل ناقص الأُنس؛ كان كامل الجسد، مكتمل الصورة، لكنه بلا صدى لروحه. فالوحدة ليست غياب الآخرين فحسب، بل غياب من يرى العالم بعينيك دون أن تشرح له كيف تراه. لذلك لم تكن حواء مجرد رفيقة، بل اكتشافًا وجوديًا مزلزلًا: أن للروح مرآة خارجها، وأن الإنسان لا يكتمل إلا حين يجد من يشبهه دون أن يطابقه.
في الجنة لم يكن الحب قصة ولا مغامرة ولا خطرًا، لأنه لم يكن هناك ما يُهدده. لا جوع يجعل أحدهما يحتاج الآخر، ولا تعب يستدعي المواساة، ولا زمن يخطف اللحظات من بين الأيدي. كان الحب صفاءً خالصًا، حالةً من الهدوء المطلق، أشبه بماء ساكن لا تعكره الريح. لكن الصفاء المطلق يحمل في داخله هشاشته؛ فالكائن الذي لم يختبر النقص لا يعرف قيمة الكمال، والذي لم يُمنع من شيء لا يدرك معنى الاختيار. من هنا تسلّل الفضول، لا بوصفه نزوة عابرة، بل بوصفه أول إعلان أن الإنسان ليس مجرد كائن يتلقى، بل كائن يريد أن يعرف حتى لو كان الثمن سقوطه.
لم تكن الحكاية تفاحةً بقدر ما كانت لحظة وعي مفاجئ. لحظة انتقل فيها الإنسان من العيش داخل النعمة إلى تأملها من الخارج. حين أكل آدم وحواء لم تتغير معدتاهما بقدر ما تغيّرت رؤيتهما لأنفسهما. فجأة اكتشفا الجسد، لا كوعاءٍ بريء، بل كحقيقة قابلة للانكشاف والحكم والخجل. اكتشفا أنه يمكن أن يُرى الإنسان وأن يُقاس وأن يُخفِي. كانت تلك اللحظة هي ولادة الشعور بالعُري بمعناه النفسي، لا الفيزيائي فقط؛ عري الروح أمام ذاتها.
لم يكن الهبوط إلى الأرض انتقالًا جغرافيًا بقدر ما كان تحوّلًا في طبيعة الوجود. الجنة مكان تُعطى فيه الأشياء بلا مقابل، أما الأرض فهي المكان الذي تُنتزع فيه الحياة انتزاعًا. هناك تعلّم آدم لأول مرة معنى الشقاء، أن يمد يده فلا يجد، وأن يعمل ليأكل، وأن يخاف ليحتمي، وأن يسهر ليحرس. لم يعد الطعام هبة، بل نتيجة، ولم تعد الحياة سكونًا، بل صراعًا دائمًا مع الطبيعة والزمان. ورأت حواء هذا التحول يحدث أمامها: الرجل الذي كان رفيق الصفاء صار كائنًا يكدّ ويتعب ويتألم، يحمل على كتفيه عبء البقاء.
هنا وُلد نوع جديد من الحب لم تعرفه الجنة: حب الامتنان. لم تعد العلاقة مجرد وجودٍ مشترك، بل تضحية متبادلة. اقتربت حواء من آدم لا لأنها وحدها، بل لأنها رأت فيه من يشقى لأجلها. ورأى آدم في هذا الاقتراب راحةً تعوّض قسوة العالم، كأن وجودها يقول له إن تعبه ليس عبثًا. ومن هذا التبادل الصامت تولد المشاعر الأرضية الحقيقية: الشوق، الحنان، الخوف من الفقد، والرغبة في ألا يختفي الآخر أبدًا.
ثم جاء التلامس، لا بوصفه رغبة جسدية فحسب، بل إعلانًا أن الإنسان لم يعد روحًا خالصة. ومن التلامس جاء الحمل، ومن الحمل جاءت الولادة، ومن الولادة جاءت الكثرة، ومع الكثرة جاءت المسؤولية الثقيلة: أن يستمر الإنسان لا كفرد، بل كنوع. لكن مع الأبناء ظهر ما لم تعرفه الجنة: المقارنة. لم يعد الحب موزعًا بالتساوي، بل صار موضوعًا للاختيار والغيرة والتنافس. ومع أول اختلاف ظهر أول انكسار، ومع أول شعور بالظلم وُلد الغضب، ومع الغضب سُفك أول دم.
لم يكن الدم الذي سال دم عدوٍ غريب، بل دم أخ. وهنا اكتشف الإنسان أخطر حقيقة في وجوده: أن القلب الذي يعرف الحب قادر أيضًا على حمل الكراهية، وأن القرب الشديد قد يكون أخطر من البعد، لأن من يستطيع أن يجرحك بعمق هو من يعرف مواضع ضعفك. منذ تلك اللحظة لم يعد الحب قوةً نقية، بل صار قوة مزدوجة تحمل في داخلها إمكانية البناء والهدم معًا.
ومنذ ذلك السقوط الأول، لم يعد الحب مجرد نعمة، بل صار اختبارًا. قد يكون فراقًا يقتل ببطء، لأن الذاكرة تظل حيّة بينما يموت الحاضر. وقد يكون كذبًا يدفن الثقة فلا تعود قادرة على التنفس. وقد يكون طمعًا يحوّل الإنسان من غاية إلى وسيلة، ومن حبيب إلى مورد. وقد يكون إهمالًا صامتًا، لا صراخ فيه ولا خيانة، لكنه يُطفئ القلب كما تُطفأ شمعة حين ينفد هواؤها. أخطر أنواع القتل ليس ما يُنهي الحياة فورًا، بل ما يتركها تستمر بلا معنى.
لذلك فإن عبارة «قتل المحب حبيبته… وقتلت المحبة حبيبها» ليست دائمًا وصفًا لجريمة تُسجَّل في دفاتر الشرطة، بل وصفٌ لحقيقة إنسانية تتكرر منذ خرج الإنسان من الجنة. فالحب حين يفقد صدقه يتحول إلى نقيضه دون أن يغيّر اسمه، فيصبح القاتل هو ذاته الذي كان من المفترض أن يكون ملاذًا. وقد يبقى الجسد حيًا، لكن شيئًا أعمق يموت: القدرة على الثقة، على الطمأنينة، على أن يفتح الإنسان قلبه مرة أخرى دون خوف.
هكذا لم يُطرَد الإنسان من الجنة إلى الأرض فقط، بل طُرِد من حبٍ بلا ألم إلى حبٍ لا يعيش إلا بالألم. في الجنة كان الحب هدوءًا أبديًا، وعلى الأرض صار عاصفة لا تهدأ. وفي كل قصة عشق تنتهي بانكسار أو جريمة أو صمت بارد، يتكرر ذلك السقوط القديم بصورة جديدة، كأن التاريخ لا يعيد نفسه في الحروب فقط، بل في القلوب أيضًا.
وربما لهذا السبب لا يكون أخطر ما في الحب أن ينتهي، بل أن يتحول إلى شيءٍ يشبهه في الشكل ويخالفه في الجوهر؛ أن يبقى الاسم بينما تموت الحقيقة. عندها لا يحتاج القتل إلى سلاح، لأن الضحية تسير على قدميها، تتنفس، تبتسم، وتبدو للناس حيّة… بينما في داخلها مقبرة كاملة لما كانت عليه يومًا.
وهكذا، كلما سمعنا عن عاشقٍ قتل معشوقته، أو عاشقةٍ قتلت حبيبها، لا نكون أمام حادثة منفصلة بقدر ما نكون أمام ذروة مأساوية لمسار بدأ منذ اللحظة التي اختار فيها الإنسان أن يعرف أكثر مما ينبغي. فالحب الذي وُلد في الجنة بلا خوف، حين يسقط إلى الأرض يحمل معه هشاشته، ويبحث طوال العمر عن طريق العودة… طريقٍ لا يجده أبدًا.
لأن الحقيقة التي لا يريد أحد الاعتراف بها هي أن الإنسان لا يقتل من لا يعنيه أمره، بل يقتل — بالسكين أو بالكلمة أو بالصمت — من كان يومًا جزءًا من حياته، من عرف نقاط ضعفه، من سكن قلبه حتى صار إخراجه منه أشبه بانتزاع عضوٍ حي. لذلك يبدو القتل في الحب كأنه محاولة يائسة لقتل الذكرى نفسها، لا الشخص فقط، كأن العاشق يريد أن يمحو الدليل الوحيد على أنه كان ضعيفًا يومًا.
وفي النهاية لا يكون السؤال: لماذا قتل؟
بل: لماذا أحبّ إلى هذا الحد الذي جعل القتل يبدو له خلاصًا؟
وهناك، عند هذه النقطة تحديدًا، ندرك أن أخطر ما في الحب ليس أنه قد ينتهي بالموت… بل أنه قد يبدأ بالحياة ثم يكتشف صاحبه متأخرًا أنه منذ اللحظة الأولى كان يسير — وهو يبتسم — نحو هاوية لا قاع لها.
ثم نكتشف الحقيقة الأكثر إيلامًا: أن الحب لا يموت حين يرحل صاحبه، بل حين يتبدل معناه. قد يبقى الحبيبان في المكان نفسه، تحت السقف ذاته، يتبادلان الكلمات اليومية نفسها، لكن شيئًا غير مرئي يكون قد انكسر نهائيًا. لا صراخ، لا دماء، لا وداع رسمي… فقط فراغ يتمدد بين قلبين كانا يومًا أقرب من النفس إلى الصدر. هذا الفراغ هو القاتل الحقيقي، لأنه لا يمنح ضحيته حتى شرف النهاية، بل يتركه يتآكل ببطء، يرى نفسه يتغير ولا يستطيع إنقاذ ما كان.
وعندها يتحول الحب من وعد بالحياة إلى عبءٍ ثقيل، ومن ملاذٍ إلى قفص، ومن دفءٍ إلى واجب بارد. يبدأ كل طرف في دفن الجزء الذي كان يضيء داخله كي يستطيع الاستمرار، فيعيش بنصف قلب ونصف روح ونصف رغبة في الوجود. وهذا النصف الباقي لا يعيش… بل يؤدي وظيفة الحياة فقط. هنا لا يكون القتل لحظة، بل عملية طويلة، أشبه بقطع شجرة عريقة ببطء شديد حتى تسقط وحدها دون صوت.
لهذا تبدو بعض جرائم العشق في ظاهرها جنونًا مفاجئًا، لكنها في حقيقتها نهاية منطقية لمسار طويل من التآكل الداخلي. فالإنسان لا ينفجر فجأة، بل يمتلئ تدريجيًا حتى يعجز عن احتواء نفسه. وما يبدو لحظة طيش قد يكون حصيلة سنوات من الخوف والغيرة والإهمال والشعور بأن ما يملك روحه يوشك أن يُنتزع منه. عندها يتحول الحب من مشاركة إلى امتلاك، ومن امتلاك إلى خوف، ومن خوف إلى عنف، لأن الإنسان — في أعمق أعماقه — يخشى الفراغ أكثر مما يخشى الذنب.
وهكذا نعود إلى البداية دون أن نشعر: إلى تلك اللحظة الأولى التي عرف فيها الإنسان أنه يمكن أن يفقد. في الجنة لم يكن هناك فقد، لذلك لم يكن هناك خوف، ولذلك كان الحب هادئًا. أما على الأرض، فالحب يعيش تحت ظل الفناء، وكل عاشق يعرف — ولو دون وعي — أن ما يحبه قابل للغياب في أي لحظة. ومن هذا الوعي يولد التعلق، ومن التعلق يولد القلق، ومن القلق قد يولد الجنون.
لهذا لا يكون السؤال الحقيقي: لماذا يقتل العشاق؟
بل: لماذا يخافون إلى هذا الحد من أن يعيشوا بلا حب… حتى لو كان هذا الحب نفسه يدمّرهم؟
وربما لأن الإنسان، منذ خروجه من الجنة، لم يتوقف عن البحث عن شيء واحد: مكان لا يفقد فيه من يحب. وحين يعجز عن إيجاد هذا المكان في العالم، يحاول — بوعي أو بغير وعي — أن يصنعه داخل شخص واحد. فإذا اهتز هذا الشخص، اهتز العالم كله، وإذا غاب، بدا كأن الوجود نفسه قد انهار.
وهكذا، بعد آلاف السنين من السقوط الأول، لا يزال الإنسان يحمل داخله حنينًا غامضًا إلى حبٍ بلا خوف… حبٍ يشبه ما كان قبل أن يعرف الفقد. لكنه لا يجده، لأن الأرض ليست مكان هذا النوع من الحب. الأرض مكان التجربة، لا البراءة؛ مكان الزمن، لا الخلود.
لذلك يظل الحب أعظم ما في الإنسان… وأخطر ما فيه أيضًا.
فهو الشيء الوحيد القادر على أن يجعله مستعدًا للحياة من أجل شخص… أو للموت بسببه… أو لقتل نفسه أو غيره كي لا يعيش بدونه.
وعند هذه النقطة تحديدًا، لا يعود السؤال من قتل من، ولا كيف حدثت الجريمة، بل سؤال واحد فقط يتردد في عمق التجربة الإنسانية كلها:
هل كان سقوط الإنسان من الجنة عقوبة… أم كان بداية قصة لا يمكن أن يكون لها إلا هذا القدر من الألم؟

